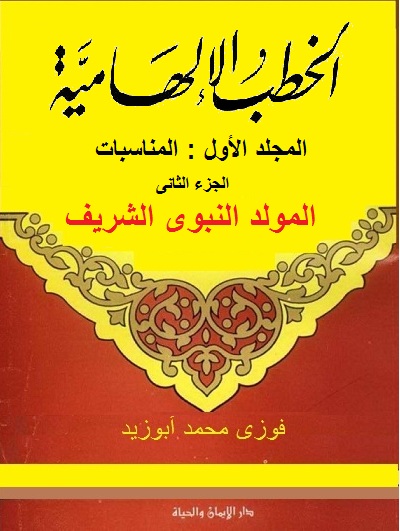لقد بُعث صلى الله عليه وسلم والعوالم كلها في الأرض في غاية الهمجية،
كأنهم وحوش ترعى في البرية، يأكل قويِّهم ضعفيهم، ولا يعترف كبيرهم بمدى ضعف صغيرهم فيرحمه، يقتتلون على أتفه الأسباب، تقوم الحرب بين القبائل لمدة تزيد عن أربعين عاماً من أجل أن فرساً من هذه القبيلة سبق فرساً لهذه القبيلة، ما هذه العقول؟!
تنشأ الحرب لأن هذه القبيلة تريد أن تسيطر وحدها على الماء، ولا تسقي عباد الله الظماء من الماء،
مع أن الماء نازل من الله، وقد كفله لجميع عباد الله.
حتى الأمم التي تظاهرت بالمدنية في هذا الزمان، وهم الفرس والرومان، وكانتا أعظم دولتين في ذلك الوقت، مع ما أبدعوه من المدنيَّة والحضارة، فلم يكن هناك أي مبدأ للمساواة، ولا أي حد ولو أدنى للعدالة، ولا أي نصيب ولو قليل للفضائل التي بها يتميز الإنسان عن عالم الحيوان، بل إن عالم الحيوان لو بحثنا فيه نجد فيه فضائل يتعجب منها الإنسان اللبيب الفصيح،
فهذه الكلاب مع خسَّتها ومع دنائتها لو مات كلب منها
مع أنها تأكل الجيف وتسارع وتتقاتل من أجل أكل لحوم الجيف إلا أنها لا تأكل لحم كلب مثلها،
احتراماً لجنسها، واحتراماً لحقوق بني جنسها،
فإذا رأوْا كلباً ملقى في الطريق يشمونه ولا يأكلون منه ويتركونه، احتراماً لجنسيتهم.
وهذه الجمال لا تأتي ذكورها إناثها إلا إذا تغطَّت عن أعين الناظرين حياءاً من هذا الفعل وكأن الله عز وجل أمرها بالستر حتى لا يراها المستهترون من الإنس الذين هبطوا عن درجة الحيوانية التي تراعيها الجمال عندما تهمُّ ذكورها بإناثها فضائل كثيرة وكثيرة لا نستطيع عدَّها في هذا الوقت القصير لهذه الحيوانات.
فما بالكم بعوالم الطيور؟،
إن ابن آدم عندما قتل أخاه، حمله على ظهره أياماً طويلة، وقد احتار في أمره، ماذا يفعل نحوه؟ حتى علَّمه الله على يد الطير، فرأى غراباً قد مات، وهبط غرابٌ آخر حنونٌ عليه لأنه من بني جنسه وحفر له حفرة وألقاه فيها وسوَّى عليه بالتراب، فقال كما أنبأنا الله:
(يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَـذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءةَ أَخِي) (31المائدة)،
فكأن الذي لا يستر سوءة أخيه أذلَّ من الغراب، وأهبط من درجة الغراب، والذي يأكل لحم أخيه بالغيبة والنميمة أخسَّ من معدن الكلاب، ومن فصيلة الكلاب!، وهكذا الأمر يا جماعة المؤمنين.
بعث هذا النبي في وسط غابة من الحيوانات المتوحشة في صورة آدمية، بعضهم يعبدون الطاغوت، وبعضهم يعبدون أشخاصاً نصبوهم ملوكاً أو رؤساء، وبعضهم يعبدون البقر، وبعضهم يعبدون الحجر، وبعضهم يعبدون وثناً صنعوه من الشجر، وبعضهم يعبدون صنماً صنعوه مما تشتهي أنفسهم، فإذا جاعوا أكلوه، وصنعوا عند الميسرة صنماً آخر يعبدوه. بعث هذا النبي الكريم فردَّ للإنسان كرامته، وعرف الإنسان على جميع حالته، وعرفه بالفضل العظيم الذي أولاه له المولى الكريم سبحانه وتعالى.
فعرف الإنسان أنه هو المقصود من الأكوان، لأن الله خلق كل شئ في الدنيا لبني الإنسان، فسخر الشمس لنا، وسخر البحار لنا، وسخر الطير والحيوانات لنا، وسخر الأشجار والنباتات لنا، وسخر لنا ملائكة السماء، منهم من يحفظوننا، ومنهم من يجلبون أرزاقنا، ومنهم من يهيئون في الجنة مكاننا، ومنهم من يستغفرون لنا، ومنهم من يدعون الله لرفع البلاء عنا، ومنهم ومنهم، .وكلهم مسخر للإنسان، والإنسان مُسخَّر للديان عز وجل.
فعلَّم الإنسان، وأنبأ الإنسان، أنه خُلق لحضرة الواحد الديَّان، فلا يعبد سواه، ولا يخضع ولا يحني جبهته إلا لله، حتى دخل الرجل الفقير المسلم على قيصر ملك الروم، وأراد حاشيته أن يعلموه كيفية الدخول على الملك
فقالوا له: إذا دخلت عليه فاسجد بين يديه، ولا تقم من سجدتك حتى ينادي عليك ويقول لك قم، فقال: هذا ليس في ديننا، لأن الله عز وجل أعزَّنا حتى لا تسجد جباهنا لسواه، وبعد مداولات احتاروا ماذا يفعلون؟ فتفتقت عبقريتهم بأن أتوا بصانع ماهر على جناح السرعة، وأمروه بأن يصنع باباً صغيراً لا يدخل منه الداخل إلا بعد انحناء ظهره، كل ذلك خوفاً من مليكهم، مع أنه عبدٌ مثلهم، لا يملك لنفسه ضرَّاً ولا نفعاً، ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً إلا بإذن الله عز وجل وأمره،
لكن المسلم الذي أعزَّه الله بدين الله ألهمه الله في الحال ما به يظل عزيزاً بين الناس، حتى ولو دخل على ملوك الأرض، ماذا يفعل؟، جلس على إليتيه ومَدَّ رجليه وفخذيه وجعل قدماه في وجه الملك، حتى لا يسجد إلا للحي الذي لا يموت
(وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ) (8المنافقون).
هذه العزيمة الإيمانية تعلموها على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخلقوا بالعفَّة التي جعلت حياتهم آمنة مطمئنة، لا يخافون وإن خاف الناس، ولا يرتاعون وإن ارتاع الناس، لأنهم يلقون حاجاتهم وأشياءهم بين الناس، ويعتقدون أن الله عز وجل يتولى عنهم جميع شئونهم، ويحفظهم من أعدائهم، فكانوا ينامون ولا يغلّقون الأبواب إلا غلقاً خفيفاً اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه العفة هي التي جعلت الرجل منهم يشتري من التاجر وهو مطمئن البال إلى أنه سيحصل على حقه بلا حَيْف أو جَوْر، لأن التاجر لا يأخذ إلا الرزق الحلال.
هذه العفة هي التي جعلت الرجل منهم يطمئن على زوجته وبناته وهو على جَبَهات القتال يحارب في سبيل الله، لأن الجميع يراقب الله، ويعلم أنه مُطَّلع عليه في سرِّه ونجواه، فلا يوجد يا إخواني قانون في دنيا الناس يُطْمئن الناس على أعراضهم وعلى أموالهم، في بيعهم وشرائهم، في كل أرجاء مجتمعاتهم، إلا قانون المراقبة لمن يقول للشئ كن فيكون.
هذه المراقبة، مَنْ الذي علمها لهم؟، هو رسولكم الكريم صلوات الله وسلامه عليه،
حتى بلغ الأمر أن جند رسول الله صل الله عليه وسلم عندما دخلوا المدائن فاتحين، ورأوا كنوز كسرى وهي لا حدّ لها ولا عدّ لها، ولم يكن شيئاً قريباً منها أو يضاهيها، لم تغرَّهم ببريقها، ولم تخضعهم بوهجها، ولذلك عندما قال لهم قائدهم:
ليؤدي كل واحد منكم أمانته، أسرعوا إليه، وكل واحد أحضر بين يديه ما عثر عليه حتى الذي وجد مِخْيطاً (إبرة) أحضره وتعفَّف عن أخذه وألقاه بين يدي القائد، فكانت كنوزاً عجيبة وغريبة حملوها على ظهر الإبل - ما يقرب من أربعة آلاف كيلومتر - فكان أولها في المدينة المنورة وآخرها في بلاد فارس. فعندما وُجدت في مسجد رسول الله نظر إليها أصحاب رسول الله - وهم الحفاة العراة الذين لا يحصلون على ضرورة الحياة إلا بمشقة بالغة، ولم يسمعوا عن السندس والاستبرق إلا من رسول الله في كتاب الله - تعجبوا من هذه العفة الإيمانية التي تخلَّق بها جند الله، فقال سيدنا عمر رضي الله عنه:
{ إِنَّ أَقْوَامَاً أَدُّوا هذَا لَذَوُو أَمَانَةٍ، فَقَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه: إِنَّكَ عَفَفْتَ فَعَفَّت الرَّعِيَّةُ }(1)
(1)جامع المسانيد والمراسيل عن مخلد بن قيس الْعَجلي عن أَبيهِ